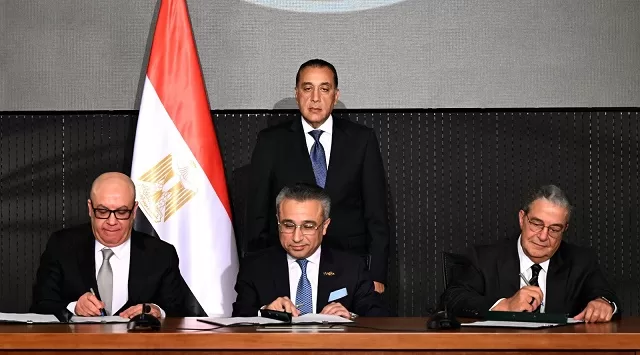ارتفعت درجات الحرارة في مصر 1.6 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية
من المتوقع ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية خلال السنوات المقبلة
خسائر متوقعة قادمة في مختلف القطاعات بسبب أزمة المناخ
ورقة بحثية تشير إلى ضرورة مراجعة بيئية للمشروعات المدنية التي تديرها المؤسسة العسكرية
قبل 53 عامًا، وتحديدًا عام 1972، خلال مؤتمر البيئة العالمي في ستوكهولم بالسويد، حاولت الدول الأوروبية فرض ضرورة إدماج الأثر البيئي أثناء التنمية الاقتصادية. إلا أن رئيسة وزراء الهند الراحلة، أنديرا غاندي، ردّت قائلة:
“لا تحدثوني عن البيئة طالما أن هناك فقرًا وعوزًا للتنمية، خاصة أنتم، دول تسببتم في زيادة معدلات التلوث داخليًا وخارجيًا، والآن، بعد أن وصلتم إلى مرحلة النمو الاقتصادي، تريدون تحميلنا تكلفة البيئة ونحن بحاجة للنمو مثلكم.”
تم الأخذ بهذا الطرح لاحقًا في قمة الأرض عام 1992، حيث جرى تقسيم العالم إلى دول نامية بحاجة للنمو، ودول متقدمة تتحمل المسؤولية التاريخية عن معدلات التلوث.
أما في عام 2018، فالمشهد يتكرر في مصر، حيث تخضع العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والتجارة، والصناعة، واستصلاح الأراضي، والبنية التحتية الخاصة بالري والمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، لإدارة جهات سيادية تهدف إلى تحقيق الأرباح. غير أن هذه التوجهات تتصادم مع مخاطر التدهور البيئي، وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، خاصة في ظل التوسع في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه الاستثمارات الحكومية.
لطالما تم التقليل من قيمة دراسات الجدوى في الخطاب السياسي المصري، بما في ذلك المشروعات البيئية. ففي ديسمبر 2018، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث متلفز:
“في تقديري، لو اعتمدتُ على دراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق فقط 20 إلى 25% مما حققناه.”
كما كرر هذا الموقف لاحقًا، معتبرًا أن الاستغناء عن دراسات الجدوى ساهم في خفض مدة تسليم المشروعات من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة في مصر بمعدل 1.6 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 درجات مئوية خلال السنوات المقبلة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن مصر ستواجه تغيرات مناخية سريعة قد تؤدي إلى خسائر في مختلف القطاعات بنسبة تتراوح بين 2% و6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2060.
من الضروري تعديل القوانين واللوائح القائمة، بحيث لا يتم استثناء أي جهة من تقييمات الأثر البيئي الإلزامية. كما ينبغي إدراج تدابير التحصين ضد التداعيات المستقبلية الناجمة عن تغير المناخ في مراحل تصميم المشروعات، لضمان تقليل الأضرار البيئية الناجمة عنها.
وفي هذا السياق، يقول صابر عثمان، الخبير البارز في تغير المناخ والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة: تعرضت مصر لظواهر جوية متطرفة، وموجات حر وصقيع، وارتفاع في نسبة الرطوبة، وفيضانات مفاجئة، وعواصف رملية وغبارية، فضلًا عن ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل الشواطئ، وتملح التربة الخصبة بفعل الغمر بالمياه.
وأشار إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر تشمل الزراعة، والموارد المائية، والري، إضافة إلى المناطق الساحلية، وصحة الإنسان، والتوسع العمراني، والبنية التحتية، والسياحة، والتنوع البيولوجي. وهي نفسها القطاعات التي تتداخل مع مشروعات البنية التحتية الممولة من الحكومة، والتي تديرها المؤسسة العسكرية.
وفقًا لورقة بحثية حديثة صادرة عن مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، بعنوان “نحو إجراء مراجعة بيئية للمشروعات المدنية التي تديرها المؤسسة العسكرية في مصر”، فإن الهيئات العسكرية تدير منذ 2014 مجموعة واسعة من المشروعات القومية في أربعة مجالات رئيسية: العقارات، والبنية التحتية، واستصلاح الأراضي، وتربية الأحياء المائية والأنشطة الاستخراجية.
وخلال الفترة بين عامي 2013 و2018، استحوذت هذه الهيئات على ما يقارب ربع مشروعات البناء والبنية التحتية والإسكان الممولة من الحكومة. كما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المدنية التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نحو 2.2 تريليون جنيه بحلول أغسطس 2020، وهو ما يمثل ما بين 27.5% و38% من مشروعات البناء الحكومية خلال نفس الفترة.

كشفت الحكومة عن خطط لتحسين المناطق العشوائية أو نقل سكانها إلى مساكن جديدة بحلول منتصف عام 2021، بتكلفة إجمالية 63 مليار جنيه مصري. كما يجري حاليًا إنشاء أو التخطيط لـ37 مدينة جديدة، بتكلفة 700 مليار جنيه، وفق تقديرات عام 2022، بهدف استيعاب نمو سكاني يُقدر بين 30 و34 مليون نسمة خلال الأربعين عامًا المقبلة.
وتتحمل المدن مسؤولية 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يزيد من احتمالات وقوع تداعيات بيئية خطيرة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها:
ضخامة المشروعات والضغط على تنفيذها في مهل زمنية ضيقة.
تجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي.
الاعتماد الزائد على الحلول التكنولوجية.
التركيز المفرط على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، دون مراعاة باقي الأضرار البيئية.
تتسبب هذه العوامل في عواقب بيئية محتملة، من ضمنها زيادة انبعاثات الكربون، وتلوث الهواء والمياه، والإفراط في استهلاك الموارد، وتدهور التربة، ما يفرض تحديات بيئية كبرى على المدى الطويل.
يقول “محمد السيد” (اسم مستعار)، أستاذ علوم المناخ وخبير النظم البيئية، لمنصة”MENA“: قبل الإجابة عن تساؤل “الأرباح أم البيئة؟”، علينا طرح عدة أسئلة: هل كنا بحاجة إلى هذه المشروعات؟ وهل جدواها الاقتصادية مفيدة؟ هنا يجب الأخذ في الاعتبار هذه المعايير قبل البحث في وجود تصادم بين التنمية الاقتصادية ودراسات الجدوى ودراسات تقييم الأثر البيئي، خاصة أن هذه المشروعات كانت ضرورية. فالرقعة الزراعية تعرضت للتفتت منذ الستينيات وتآكلت بفعل قانون الإصلاح الزراعي وزيادة تجريف الأراضي، ما أدى إلى تقلص الأراضي الزراعية مقابل زيادة سكانية كبيرة، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى مشروعات زراعية واسعة.
يشرح “السيد” لمنصة “MENA“، إلى أن “دراسات الجدوى الاقتصادية” تعني خضوع المشروع لحسابات الربح والخسارة، وفي ظل حاجة البلاد إلى مشروعات عملاقة، يمكن أن تقلل هذه الحاجة من أهمية مثل هذه الدراسات. فهناك 120 مليون مواطن مصري بحاجة إلى مشروعات الإسكان والإنتاج الزراعي والحيواني والمصانع والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية. ويرى أن المشكلة تكمن في عدم إدارة المشروعات بشكل رشيد، إذ كان من المفترض زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، لكن ما حدث هو استئثار الدولة بالنصيب الأكبر، ما شكل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة وزاد من معدلات الاقتراض. في المقابل، كان يمكن أن تقتصر الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل توصيل المرافق وشبكات الطرق، ثم إسناد مراحل البناء إلى شركات القطاع الخاص مع التحكم في هامش الأرباح.
يضيف “السيد”: “ما حدث هو دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنفيذ مشروعات إسكانية كان يمكن الاستغناء عنها، وتقليل حجم الإنفاق على المباني الفاخرة مثل المساجد والكنائس والأبراج الشاهقة. فنحن لسنا بحاجة إلى التوسع الرأسي في البنايات حتى 30 و40 طابقًا، خاصة أننا نمتلك مساحات صحراوية شاسعة تتيح التوسع الأفقي. حتى العاصمة الإدارية الجديدة كان يمكن تنفيذها بطريقة مختلفة، مع الإشارة إلى أن فكرة نقل الحكومة من القاهرة ليست جديدة، إذ تعود جذورها إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أنشأ مدينة السادات لهذا الغرض، لكن المشروع توقف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. ومع ذلك، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في طريقة التنفيذ، خاصة أن هناك تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة البرازيل في نقل عاصمتها من ريو دي جانيرو إلى برازيليا”.
في يناير 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تسليم 31 ألف مشروع بتكلفة 5.8 تريليونات جنيه مصري بحلول نهاية عام 2020. في الوقت ذاته، صرحت وزارة التخطيط بأن 25 ألف مشروع بناء قد أُنجز أو كان قيد التنفيذ بتكلفة تجاوزت 4 تريليونات جنيه بين عامي 2014 و2021، بينما أعلنت القيادة السياسية في يوليو 2022 أن الدولة أنفقت 8 تريليونات جنيه على البنية التحتية الأساسية منذ عام 2014. كما بنت الدولة 1000 جسر وأضافت 17 ألف كيلومتر من الطرق السريعة متعددة المسارات إلى شبكة الطرق منذ عام 2014، ما أدى إلى تخفيف الازدحام المروري وخفض معدل تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بنسبة 4%.
ووفقًا لدراسة صادرة عن البنك الدولي في عام 2023، فقد ساهم ذلك في تقليل معدل الوفيات، ما حقق مكاسب اقتصادية بقيمة 110.4 ملايين دولار تقريبًا. ومن المتوقع تحقيق مكاسب إضافية بفضل تطوير النقل النهري والسكك الحديدية، رغم أن هاتين الوسيلتين لم تساهما سوى بنسبة 5% من إجمالي حركة شحن البضائع في عام 2022. ويشار إلى أن قطاع السكك الحديدية حصل على 11% من إجمالي ميزانية النقل في العام نفسه.
بدوره، يقول أستاذ علوم البيئة والمناخ ومدير إحدى الجمعيات الأهلية “محمد علي” (اسم مستعار)، إن المشروعات كانت تُنفذ سابقًا دون إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، لكن في السنوات الأخيرة بدأ التوجه نحو الالتزام بهذه الاشتراطات، حتى وصل الأمر إلى إصدار قرارات بمنع حفر الآبار دون تصاريح. ويضيف أن أغلب المدن الجديدة ومشروعات تحلية المياه ومترو الأنفاق تمت بعد استكمال دراسات تقييم الأثر البيئي، خاصة أن هذه الدراسات لا تمثل عائقًا أمام الدولة، إذ تتم الموافقة عليها دون مناقشة فعلية، وبالتالي يمكن استكمالها بسرعة.

ويؤكد “علي” لمنصة “MENA“، أنه إذا كان تمويل المشروع من جهة أجنبية مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الجهات تشترط تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي باللغة الإنجليزية وتسليمها في وقت محدد، سواء كان المشروع محطة كهرباء أو محطة معالجة أو صرف صحي. أما في المشروعات الممولة حكوميًا، فقد لا يتم الالتزام بهذه الدراسات. علمًا بأن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يلزم جميع الجهات، دون استثناءات، بتقديم دراسات الأثر البيئي، لكن عادةً ما يتم تصنيف هذه المعلومات تحت بند “الأمن القومي”، ما يحد من إمكانية التقييم المستقل للتأثيرات البيئية للمشروعات.
أعلنت الحكومة عن استصلاح 3.5 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية (ما يعادل 14,700 كيلومتر مربع) وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الرقعة الزراعية في مصر بنحو الثلث. إلا أن استصلاح هذه الأراضي يتطلب حفر آلاف الآبار، وإنشاء محطات ضخ كبيرة، ومد مئات الكيلومترات من الترع، ما يطرح تحديات بيئية.
ويشير الخبير البيئي إلى أن وزارة البيئة لن توافق على حفر آبار دون تقديم دراسات تفصيلية تتضمن نوعية المياه، وسعة البئر، وخرائط التحليل المائي، إلى جانب الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للموارد المائية.
رغم أن تبطين الترع ساهم في تقليل نسبة التسرب، إلا أنه أدى أيضًا إلى انخفاض منسوب المياه في الأحواض الجوفية وزيادة ملوحة التربة، ما تسبب في تدهور جودة الأراضي الزراعية وتراجع وفرة الثروة الحيوانية والنباتية غير الزراعية. كما أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة معدل التبخر، ما رفع الطلب على مياه الري بنسبة تتراوح بين 7% و13% في المحاصيل الصيفية والشتوية على التوالي، وهو ما يفاقم أزمة ندرة المياه في مصر.
الدكتور “علي فهيم” (اسم مستعار)، خبير البيئة العالمي، يقول لمنصة “MENA“: “تتقدم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شأنها شأن باقي الهيئات، بطلبات إلى وزارة البيئة لتقييم المشروعات من الناحية البيئية، التي تُصنف إلى ثلاثة مستويات: أ، ب، وج. ويعد المستوى الثالث (ج) الأكثر خطورة، حيث يشمل مشروعات مثل البترول، المحارق الكبيرة، والمصانع الضخمة، التي تتطلب درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 300 درجة مئوية، مما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة.”
ويضيف أن وزارة البيئة تشترط إنشاء وحدات للسيطرة على الانبعاثات، من خلال التحكم في ستة عناصر رئيسية: الكربون، النيتروجين، الكبريت، الهيدروكلوروكربون، البايوكلوروكربون، وغاز الميثان. كما يشير إلى إمكانية تحويل هذه الانبعاثات إلى مصادر طاقة نظيفة مثل “البيوغاز” أو “البيوماس”، خاصة مع توفر المخلفات الزراعية التي تصل إلى 35 مليون طن سنويًا.
ووقّعت مصر اتفاقًا مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء محطة كهرباء بنظام الدورة المركبة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعزز استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في العقود القادمة. وعلى الرغم من تزايد التركيز على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، تشير الخبيرة البيئية “لمى الحتو” إلى أن الغاز ليس بديلاً نظيفًا عن الفحم والنفط، خاصة مع تأثير ارتفاع درجات الحرارة على كفاءة توليد الكهرباء من الغاز والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
من جانبه، يؤكد “محمد السيد”، خبير النظم البيئية، لمنصة “MENA“، أن “الطاقة الجديدة والمتجددة لا يمكنها أن تحل بالكامل محل الوقود الأحفوري، إذ لا يمكن لأي دولة في العالم خفض اعتماده عليه إلى أقل من 70%.” ويضيف: “مصر لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الطبيعي، ولكن يمكن تحقيق مزيج من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، رغم التحديات المرتبطة بالمناخ الصحراوي والعواصف الترابية التي تؤثر في كفاءة المحطات الشمسية وترفع تكلفة صيانتها.”
ويشير إلى أن التجربة الفرنسية توضح أهمية هذا التنوع في مصادر الطاقة، إذ تمتلك فرنسا أكثر من 80 محطة طاقة نووية، ورغم ذلك لا تزال بحاجة إلى الغاز الطبيعي الروسي.
وفقًا لتقرير صادر عن “مشروع حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية، فإن “رغم الترويج للمدن الجديدة على أنها صديقة للبيئة، إلا أنه لا يوجد أي إلزام باتباع نظم التقييم البيئي، مثل نظام الهرم الأخضر المصري. بل على العكس، تعتمد المخططات المعمارية لهذه المدن على المباني الشاهقة ذات الواجهات الزجاجية، التي تزيد من الاحتباس الحراري داخل المباني وترفع استهلاك الطاقة المستخدمة في التبريد.”
كما يشير التقرير إلى أن الإسمنت، الذي يُعد المكون الأساسي في عمليات البناء، يعد من أكثر مواد البناء تلويثًا للبيئة، حيث تمتص الأسطح الإسمنتية نحو 95% من أشعة الشمس، ثم تعيد بثها، مما يسهم في رفع درجات الحرارة في المدن. ويضيف التقرير أن “عدد المشروعات التي تعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة لا يزال محدودًا جدًا في مصر، رغم مخاطر البناء الخرساني.”
في عام 2020، كان نحو 83% من سكان القاهرة يعيشون في مناطق تقل فيها المساحات الخضراء عن 1.5 متر مربع للفرد، أي ما يعادل سدس التوصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ألا يقل نصيب الفرد من المساحات الخضراء عن 9 أمتار مربعة.
وتعد المساحات الخضراء والترفيهية ضرورية للصحة النفسية والبدنية، ولتنمية الأطفال اجتماعيًا، لكنها تكاد تكون معدومة لغالبية المصريين. وتشير البيانات إلى أن إجمالي إنفاق الدولة على المنشآت الرياضية بين عامي 2018 و2023 بلغ 14.5 مليار جنيه مصري (نحو 0.84 مليار دولار)، وهو مبلغ يقل بكثير عن 2.8 مليار دولار التي تم إنفاقها على بناء المدينة الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية.
اقرأ أيضًا:
التغيرات المناخية هل تؤثر على الزراعة المصرية
ممرات إسرائيلية تهدد التجارة المصرية.. ما القصة؟
لُغـز مرض أسوان الغامض.. كوليرا أم نزلات معوية؟
صفقات الاستثمار الإماراتية في مصر.. من المستفيد؟